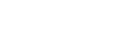في قرية الشراقوة التابعة لمركز ديروط بأسيوط، تُختصر حكاية “الجمهورية الجديدة” كما يراها كثيرون في مشهد واحد: مدرسة ابتدائية هُدمت منذ نحو عشر سنوات ولم تُعد بناؤها، بينما يُدفع الأطفال يوميًا لقطع كيلومترات نحو مدارس المدينة، وسط مخاطر الطريق واحتمالات الحوادث والخطف.
وفي المقابل، تُقدّم الدولة صورتها عبر مشروعات عملاقة ومدن جديدة ومنشآت فاخرة تُستهلك فيها المليارات. الفارق بين المشهدين ليس مجرد تباين تنموي، بل اختيار سياسي واضح للأولويات: واجهات باهرة في الأعلى، وحقوق أساسية مهملة في القاع.
وبينما يبني السيسي القصور الرئاسية، والعاصمة والمدن الجديدة، ويرمم "معابد" أهله وعشيرته بمليارات الدولارات، مدرسة ابتدائية في قرية "الشراقوة" بمدينة ديروط محافظة أسيوط بصعيد مصر، هُدمت قبل عشر سنوات والدولة في "الجمهورية الجديدة" لا تملك ميزانية لإعادة بنائها، وتجبر الأطفال على… pic.twitter.com/Dd6VJGOhqa
— عبدالحميد قطب (@AbdAlhamed_kotb) January 21, 2026
دولة تُفاخر بالخرسانة… وتتعثر أمام فصل دراسي
حين تعجز سلطة تمتلك أجهزة وإمكانات هائلة عن إعادة بناء مدرسة ابتدائية في قرية، فالمشكلة ليست “ميزانية” بالمعنى المحاسبي، بل موازنة ضمير. المدرسة ليست ترفًا ولا مشروعًا يمكن تأجيله؛ هي الحد الأدنى لحق دستوري ومعيشي. لكن ما يحدث عمليًا—بحسب رواية الأهالي—أن الدولة تعامل تعليم الريف كملف ثانوي يمكن ترحيله، بينما تُسرّع وتيرة الإنفاق على مشروعات تُسوَّق كرموز قوة وهيبة.
النتيجة أن أطفالًا في عمر لا يحتمل المخاطرة يتحولون إلى “ركّاب يوميين” في طرق غير آمنة. وعندما تُترك الأسرة وحدها أمام هذا العبء، يصبح التعليم نفسه تكلفة إضافية: مواصلات، وقت ضائع، خوف دائم، واحتمال انقطاع مبكر. هذه ليست تنمية؛ هذه تعميق للفجوة بين من يملكون الخدمات قربهم، ومن يُطلب منهم دفع ثمن المسافة لأن الدولة قررت ألا ترى قريتهم.
الطريق إلى المدرسة: رحلة قاسية تُنتج خوفًا وانقطاعًا
إجبار الأطفال على قطع مسافات طويلة يوميًا ليس مجرد معاناة نفسية، بل وصفة جاهزة للمخاطر: حوادث طرق، تحرش، ابتزاز، واختفاءات محتملة—خصوصًا في الطرق الزراعية أو المناطق الأقل مراقبة. والأخطر أن الخوف لا يظل شعورًا عابرًا؛ يتحول إلى قرارات.
كثير من الأسر عندما تُحاصرها المخاطر تختار “الحل الآمن”: بقاء الطفل في البيت، أو التحاقه المتقطع، أو التحويل إلى عمل مبكر، أو تزويج مبكر للفتيات تحت ضغط “الحماية”. وهكذا تتحول مدرسة مهدمة إلى سلسلة خسائر اجتماعية: أمية جديدة، عمالة أطفال، تسرب، وفقر يُعاد إنتاجه.
والكارثة هنا أن الدولة لا تخسر أطفالًا فقط، بل تخسر فرصة صعود اجتماعي كانت المدرسة هي بوابتها الوحيدة. وعندما تُغلق هذه البوابة بالإهمال، لا يعود الحديث عن “بناء الإنسان” سوى شعار دعائي ينهار أمام أول مطب في طريق طفل.
الإنفاق العام كأداة تمييز: من يَظهر في الصورة ومن يُمحى منها
المفارقة القاسية في رواية الشراقوة أن الإهمال لا يأتي في فراغ. الناس يقارنون بين ما يسمعونه عن مشروعات كبرى ومنشآت فاخرة، وبين عجز الدولة عن إعادة بناء مبنى مدرسي بسيط. وحتى إن اختلف البعض حول تفاصيل الإنفاق، فالمحصلة الملموسة على الأرض لا خلاف عليها: القرية بلا مدرسة.
هذه المقارنة تُنتج غضبًا مشروعًا لأن الإنفاق العام هنا يتحول إلى أداة تمييز طبقي وجغرافي: ما يُرى من بعيد ويُصوَّر ويُفتتح باحتفالات يجد التمويل والسرعة، وما هو “صامت” في القرى يُترك للزمن والوعود.
وإذا كانت الدولة جادة في الحديث عن العدالة الاجتماعية، فالمعيار ليس عدد الكباري أو الأبراج، بل عدد الفصول التي تفتح أبوابها صباحًا بلا خوف ولا إذلال. بناء مدرسة ليس عبئًا على الخزانة بقدر ما هو اختبار للنية: هل تريد الدولة فعلاً مواطنًا متعلمًا في الصعيد، أم تريد صعيدًا يظل خزانًا للفقر والهجرة والاحتياج؟